حذّر الصحافي محمد حسنين هيكل منذ أيام، في حديثٍ إلى لصحيفة الـ«تايمز»، من «فراغٍ استراتيجي كبير قد يطاول سورية، أسوةً بالفراغ الذي أحدثه العراق بعد احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003».
هو فراغٌ لطالما توقّعه كثيرون وتناولوه في التحليلات والكتابات، فالعراق كان دائماً محوراً أساسياً في توازن القوى الاستراتيجية بين الأطراف المتصارعة فيه
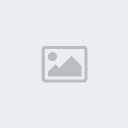
وعليه. شكّل توازناً في الصراع الدولي القائم بين المعسكرين السوفياتي والأميركي إبان الحرب الباردة، كما أمّن توازناً وثقلاً في الصراع الدولي على الشرق الأوسط، سواء من الناحية النفطية، أو السياسية والاقتصادية، أو الإيديولوجية المتمثلة في تيار القومية العربية، في الوقت الذي «تأمركت» أو «تغربنت» فيه معظم الدول العربية. إلى أن كان ما كان من تمزّق هذه الكتلة وتصدّعها بعد حرب الخليج عام 1990، أو بعد احتلال العراق عام 2003، فتركت آثاراً فادحة ما زلنا نعاني من صعوبة رأبها لغاية اليوم.
لم يعُد العراق نواةَ الاستقطاب، بل أصبح ملحقاً أو تابعاً، وجزءاً من مسألة «الصراع مع إيران» كما «الصراع السنّي ـ الشيعي»، فضلاً عن أنه سيبقى أبداً جزءاً من الصراع العالمي على الينابيع النفطية، ليصبح، والحال هذه، متلاصقاً مع الصراع، وليس فقط جزءاً منه. تصدّع الثقل التاريخي كما الجغرافي للعراق لوقوعه بين خطّين محوريَيْن أساسيَيْن: الهلال الخصيب من جهة، وشبه الجزيرة العربية من جهة أخرى.
سورية، في المقابل، هي حالياً الدولة العربية الأبرز على خطّ المواجهة، هي جزءٌ لا يتجزأ ولا يُستهان به من الناحية الجغرافية، كونها تغلق منطقة الشرق الأوسط من الجهة الغربية، وضمناً تغلق منفذ كيان العدو الصهيوني على الغرب، والسيطرة على هذه الجبهة الغربية ستجعل موازين القوى تختلّ حكماً، إذ لا يمكن أن ننسى تداعيات اتفاقية «كامب دايفيد» المصرية ـ «الإسرائيلية».
من هنا، يجب ربط الوضع القائم في سورية، وتداعيات الأزمة، بموضوع الصراع بين المقاومة اللبنانية و«إسرائيل»، فالتغيير الاستراتيجي الذي أحدثته المقاومة في موازين القوى، والذي جعل كفّة هذه الموازين تميل لمصلحة لبنان منذ الانتصار الذي حققته المقاومة عام 2006، حيث كفّت «إسرائيل» عن تبجحها، وباتت تحسب ألف حساب لأيّ هجمة محتملة على لبنان. وفي الحساب الاستراتيجي، فإن هذا لا يحسب في مصلحة لبنان فحسب، إنما له أبعاد قومية وعربية أخرى متمثلة في سورية وفلسطين.
الطامة الكبرى تكمن في أن يحلّ بسورية ما حلّ بالعراق، فتداعيات الفراغ هنا قاتلة وتثير الهلع، النتيجة الأولى ستكون في انتصار «إسرائيل»، وبالتالي تمكّن الغرب من السيطرة على كل ثروات المنطقة، التي لا تنحصر بالبترول والغاز فحسب، بل بموقع هذا النفط في حضارة العالم الغربي الصناعية التي تعيش على المحرّكات والآليات في حالة الحرب كما في حالة السلم.
وفي مراقبةٍ للمشهد المفترض، يتبيّن لنا أن أيّ انهيار على خط المواجهة في الصراع العربي ـ «الإسرائيلي»، والذي سبق أن ابتعدت عنه مصر نظراً إلى مفاعيل اتفاقية «كامب دايفيد»، ومن ثمّ «إزاحة» العراق كدولة ثقل قومي في هذا الصراع، لتبقى الجبهة السورية الممانعة التي لو حصل وانهارت، لأغلقت حينئذٍ كلّ الملفات لصالح «إسرائيل»، فيمكن حينها القول أنه إن لم تكن «إسرائيل» دولة كبرى تمتدّ من النيل إلى الفرات، فمن المؤكد أنها ستصبح دولةً عظمى وجزءاً من إدارة المنطقة ومن قواعد الاستناد التي يستند إليها الغرب بسيطرته على ثروات هذه المنطقة، ما سيسدل الستار على شرق أوسط عاصرناه وعشنا تفاصيل تاريخه، ويفتح الباب على مصراعيه للسماح لنا وبكل أسف بالولوج إلى شرق أوسط جديد، بشرّتنا به كوندوليزا رايس منذ سنواتٍ خلت، في أثناء حرب تموز.
من هنا، تعتبر سورية الحلقة الأخيرة في الصراع في الشرق الأوسط وعليه، وأضحى جليّاً وثابتاً وأكيداً أنّ من يسيطر على سورية يسيطر على الشرق الأوسط كلّه. وانطلاقاً من هذه الخلفية، يمكن تفهّم تمسّك روسيا والصين بموقفيهما الكبيرين، لكسر أحادية القطب العالمية التي تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيقها من جهة، وللحؤول دون إتمام سيطرة أميركا على الشرق الأوسط من الناحية الجيوبوليتكية.
ومن التداعيات القاتلة أيضاً لانهيار سورية، (وواهمٌ من يفترض ذلك نظراً إلى قوة سورية ووحدة جيشها ووعي شعبها وحكمة قيادتها) أن يترك هذا الدويّ مفاعيله المباشرة على القوة الإيرانية، حيث تقف إيران من الشرق بمواجهة السيطرة التركية المحتملة من الناحية الغربية، وذلك بدعم أميركي واضح.
أخيراً، لا بدّ لسورية أن تنتصر على أزمتها، وعلى المؤامرة المحاكة ضدّها، مهما بلغت التضحيات وعظمت، فباب الحرّية لا يدقّ إلا بأيدٍ مضرّجةٍ بالأحمر، وما استشهاد وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة ومعه كبار الضباط منذ أيام إلا فصل جديد من فصول هذه المؤامرة التي تعلو وتيرتها كلما أبدت سورية تماسكها وقوتها وثباتها في وجه العاصفة، لأن المراد لسورية أعظم بكثير ممّا يحدث اليوم، لأنه لا يمكن لأميركا إلا التمسّك بأحادية القطب، وبـ«إسرائيل» كدولةٍ «في الجيبة» في هذا الشرق الأوسط الذي تريده جديداً مقسّماً مشرذماً إلى دويلاتٍ طائفيةٍ إثنيةٍ متناحرة، تتلهّى بحروبها الداخلية، تاركةً الذهب بكلّ ألوانه لدولةٍ «عظمى» اسمها الولايات المتحدة الأميركية التي تعاني من انهيارٍ فظيعٍ في اقتصادها، وتريد البدائل بأيّ أثمانٍ كانت.
ليلى زيدان عبد الخالق- البناء


